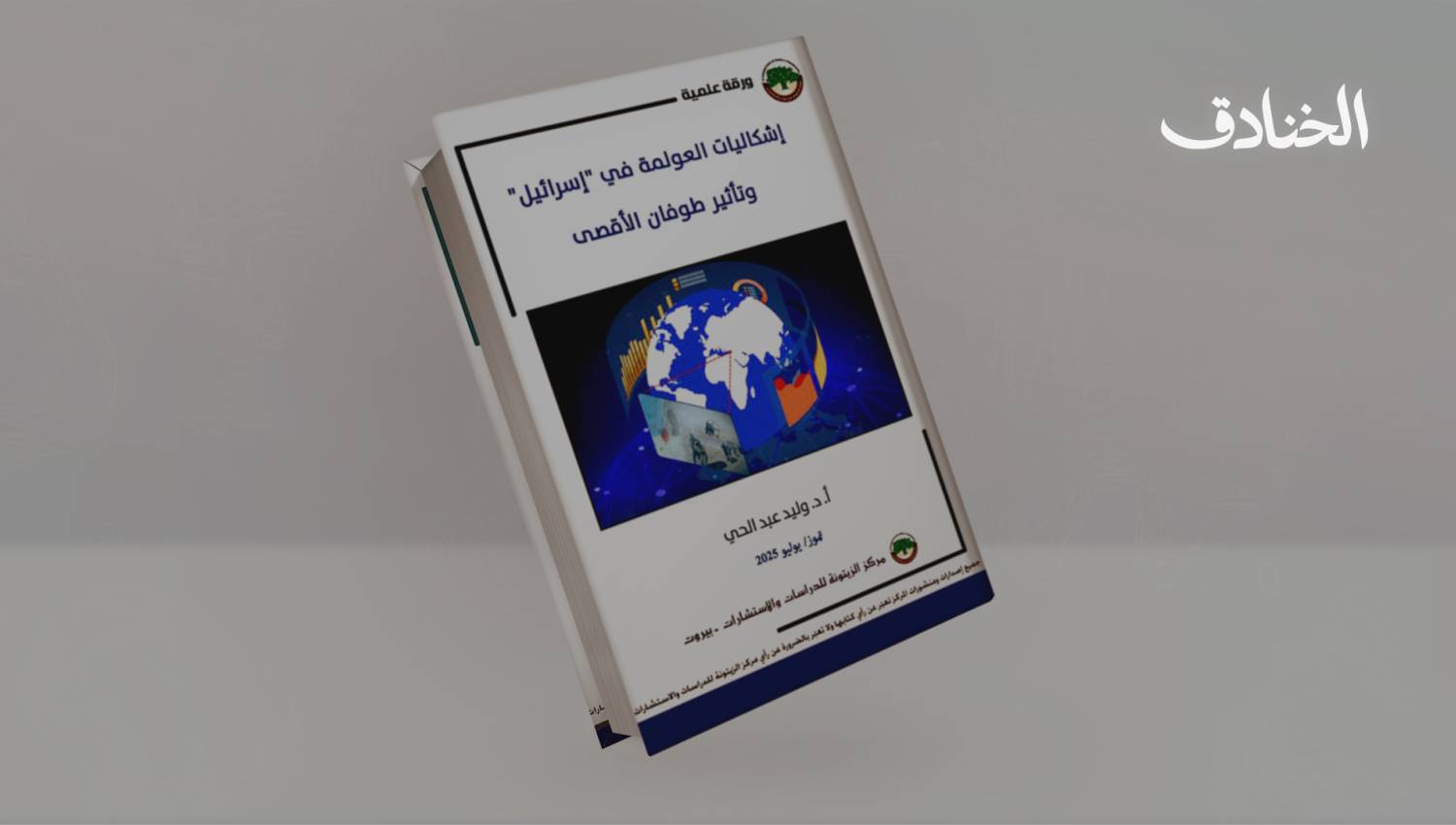
يمكن اعتبار الوجود الإسرائيلي ككيانٍ سياسيّ أحد إفرازات العولمة، فهي تضمّ مجتمعاً معولماً ينتمي سكّانه إلى عشرات الدول ذات الثقافات المتباينة. ومن المؤكد أنّ هذه الجذور الاجتماعية لسكان "إسرائيل" تُؤسّس لعولمة اجتماعية واقتصادية وسياسية. فإذا أضفنا إلى ذلك أنّ نسبة اليهود إلى إجمالي سكان العالم هي 0.2%، فإنّ نصيبهم في الثروة العالمية يبلغ 1.1%، أي أن نصيبهم يعادل 5.5 أضعاف نسبتهم السكانية، وهو ما يعني أنّهم الأكثر تأثّراً بالعولمة الاقتصادية، والأكثر عناية بتطوّرها. كما يشير البُعد السياسي، في أحد مؤشراته، إلى أنّ "إسرائيل" تقيم علاقات ديبلوماسية مع 165 دولة، إلى جانب عضويتها في عشرات المنظمات الحكومية الدولية، وتوقيعها على أكثر من 150 معاهدة دولية في مختلف الميادين، وهو ما يجعلها طرفاً نشطاً في دفع العولمة إلى الأمام.
كذلك فإنّ انتشار اليهود في عدد كبير من دول العالم يجعل منهم "قبيلة معولمة"، وهو ما يدفع "إسرائيل" إلى التواصل معهم وتوظيفهم في خدمة أهدافها، بما يجعل "إسرائيل" أشبه بشركة متعددة الجنسيات يحرص مركزها على توجيه الفروع. ولعلّ ذلك يُفسّر نزوع المؤتمر اليهودي العالمي World Jewish Congress، في ورقة بحثية منشورة سنة 2001، إلى اعتبار اليهود "ضمن محركات العولمة". بل إنّ بعض الباحثين ربط بين تطوّر واتّساع أول شركة متعددة الجنسية (شركة الهند الشرقية، سنة 1602)، وبين اليهود، خصوصاً بعد سيطرتهم عليها مع نهايات القرن السابع عشر، وهو ما جعلهم من المساهمين الأوائل في محركات العولمة.
لكن "إسرائيل"، بالمقابل، تواجه مع العولمة ثلاث إشكالات جوهرية:
- إنّ العولمة تسير في اتجاه إلغاء الخصوصيات المحلية لصالح أُطر أوسع (خصوصاً في الجانب الثقافي والإثني)، وهو ما يتناقض مع الديانة اليهودية، التي تُعد ديانة "مغلقة"، لا تقبل الدخول فيها، حسب بعض التيارات الأرثوذكسية، كما أنّها تحصر "الهوية اليهودية" فيمن هو من نسل أم يهودية، أو تقبل يهوديّته، حسب تيارات أخرى، بعد إجراءات معقّدة. وهو أمر يتناقض مع توجهات العولمة القائمة على عبور الثقافات الفرعية.
- إنّ العلمانية والترابط الاقتصادي والتقني تُشكّل التيارات الضاغطة في بناء العولمة، وهو ما يُفقد "إسرائيل" الأساس الذي بنت عليه "ذريعتها التاريخية"، أي الأساس الديني. وهنا تتضارب رؤية شمعون بيريز Shimon Peres، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مع شمولية العولمة؛ فبيريز يرى "أنّ على الكيانات السياسية أن تعيش منفصلة سياسياً عن بعضها، ولكن مترابطة اقتصادياً"، وهو أمر لا يتَّسق مع فكرة أنّ الترابط العضوي (الاقتصادي والتقني) يُضعف الترابط الآلي (الدِّين واللغة…إلخ)، طبقاً لنظريات دوركهايم Durkheim وكافة تيارات التكامل الوظيفي، القديمة والجديدة. بل يربط بعض الباحثين ورجال الدِّين اليهودي بين الاتِّساع التدريجي والهادئ في ظاهرة معاداة "إسرائيل" وبين العولمة، كما أنّ المتضررين من العولمة يرون بأنّ اليهود جزء رئيسي في إنتاج أوزار العولمة، بحكم ارتباطهم بدوائر رؤوس الأموال المحرِّكة للعولمة الاقتصادية من ناحية. ومن ناحية ثانية، فإنّ تياراً داخل اليهود أنفسهم يرى أنّ العولمة تنفث قيماً لا تتّسق مع التراث اليهودي، وهو ما يؤدي إلى انضمام معاداة العولمة الثقافية إلى معاداة العولمة الاقتصادية. ويمكن تلمّس ذلك في بعض آراء شمعون بيريز، الذي يرى أنّ التنافس بين "ثقافة الكتاب المقدّس" و"ثقافة الشاشة" يسير لصالح الثانية، وأنّ محتوى الحضارة أصبح أكثر أهمية من مكانها.
- إنّ العولمة تفترض الاتّساق السلوكي مع العضوية في المنظمات الدولية. فإذا علمنا أنّ "إسرائيل" هي الدولة الأكثر خروجاً على قرارات المؤسسات السياسية الدولية، فإنّ ذلك يجعلها في تعارض مع أحد آليات العولمة الرئيسية. ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى أنّه خلال الفترة 2006-2024، دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة UN General Assembly "إسرائيل" 170 مرة، مقابل 77 إدانة لبقية دول العالم. كما أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة UN Human Rights Council دان “إسرائيل” خلال الفترة نفسها 108 مرات، مقابل 74 لبقية دول العالم. ناهيك عن أنّ قرارات محكمة العدل الدولية International Court of Justice والمحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court (ICC) بعد طوفان الأقصى عزّزت من صورة التمرّد الإسرائيلي على قواعد العولمة السياسية.
فإذا أضفنا إلى كلّ ما سبق تنامي العزلة الدولية لـ"إسرائيل"، والتي دلّلنا عليها في دراستنا السابقة "تأثير طوفان الأقصى على مؤشرات المكانة الدولية لـ"إسرائيل"، فإنّ ذلك يشير إلى أنّ مشكلة "إسرائيل" في علاقتها بظاهرة العولمة هي أنّها علاقة تنطوي على إشكالات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وهو ما يعزّز ما ذهبنا إليه في نقد رؤية شمعون بيريز بشأن الفصل بين العولمة السياسية والاقتصادية. وهو أمر يشير إلى أنّ وهم الفصل بين أبعاد العولمة قد يقود إلى استنتاجات متعجّلة. ولعلّ المثال الأبرز على ذلك هو تنبّؤات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان Jake Sullivan، قبيل وقوع طوفان الأقصى؛ إذ إنّ سوليفان، كان يرى قبل الطوفان بخمسة أيام، أنّ الشرق الأوسط يعيش استقراراً غير مسبوق منذ عقود، نتيجة التطبيع الاقتصادي بين دول عربية و"إسرائيل". ويُرتب على استنتاجه هذا تصوراً للدور الأمريكي في العولمة.
وجاء طوفان الأقصى ليؤكد على عدم الاستقرار الكامن، الذي فجّر الصورة الخادعة في المنطقة بأكملها، وانعكست آثار هذا الانفجار على مؤشّرات العولمة، الرئيسية والفرعية، في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك "إسرائيل".
إنّ التمعّن في مؤشّرات العولمة، على المستويَين الإقليمي والعالمي، بعد الطوفان، يشير إلى صعوبة الفصل بين أبعاد العولمة المختلفة، والى انعكاس آثار هذه الأبعاد على بعضها البعض. ويكفي التأمّل في الجوانب التالية التي تأثّرت بالطوفان على الصعيد العالمي:
- ركة النقل الجوي والبري والبحري.
- مستويات التجارة الدولية، خصوصاً بين المنطقة والعالم، أو بين "إسرائيل" والعالم؛ حيث تأثّرت هذه المستويات نتيجة المواجهات العسكرية في البحر الأحمر أو بجواره، وهو ما انعكس على حجم التجارة المتّجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، أو العابرة لقناة السويس.
- معدّل الهجرة من المنطقة، خصوصاً من "إسرائيل".
- تأثّر أسعار صرف بعض العملات الوطنية.
- حجم الحراك السياسي على المستويَين الإقليمي والدولي.
- اتّساع نطاق الإجراءات القانونية من بعض الدول، سواء من خلال فرض العقوبات أم من خلال الاستجابة لطلبات المحاكم الدولية.
- التحوّلات في الرأي العام الدولي.
- تزايد معدّل العولمة العسكرية في المنطقة والعالم.
لتحميل الدراسة بشكل كامل من هنا
المصدر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات
الكاتب: أ. د. وليد عبد الحي